
قُبيل وفاته بنصفِ ساعة؛ قامَ وهوَ يُصارِع الألم، يحمل ٧٨ سنة على كاهِله فتَوضأ وصلَّى، ثم فَاضت روحه إلى بارِئها فِي التاسعِ عشر من أكتوبر عام ٢٠٠٣م/ يوم الأحد ٢٣ شعبان ١٤٢٤ھ في سراييفو. فإلى رحمةِ الله أيها الرجُل العظيم.
هَذا الرجُل غير عادي، إنه أُعجوبة فِي الفِكر والصبرِ والأخلاق. تكمن عَظَمة بيغوڤيتش في صمودِهِ وبقائهِ مُعتزاً بإسلامِهِ ومُدافعًا عنه بصبرٍ وثبات. كانَ نشيطًا في حياتهِ كلها محاضرًا وكاتباً ومُحاورا. استطاعَ أن يثبِّت وجود ٦ ملايين مسلم في وسط أوربا لم تكن لهم حقوق ولا امتيازات.
وُلِدَ في الثامنِ من أغسطس ١٩٢٥م. قالَ في آخر سيرتهِ الذاتية صـ٥٧٦: ”وُلِدت في حقبةٍ من الزَّمن بعيدة كُل البُعد عن زمنِ سعادتي“ ثم أردفَ قائلاً: ”فلو عُرِضت عليَّ الحياة مرة أخرى لرفضتها، لكن لو كانَ عليَّ أنْ أولد من جديد، لاخترتُ حياتي“.
كيفَ كانت نشأة هذا الرجل العظيم؟ لنقرأ معاً هذه السطور التي كتبها لنعرف أساس تكوينه ونفهم سبب عَظَمته، يقول:

”كانت أُمي تحرِصُ على قيامِ الليل وقراءة القرآن حتى يحين موعد صلاة الفجر، فتوقظني لنذهب معاً إلى صلاةِ الجماعة في المسجدِ القريب من بيتنا. كنتُ في ذلك الوقت بين السنة الثانية عشرة والرابعة عشرة من عمري. لم يكُن من السهلِ عليّ أن أُغادر دفء الفراش في هذا الوقت المُبكر، فكنتُ أُقاوم في بادئ الأمر، ولكني كنتُ أشعر بعد العودة من المسجدِ بارتياح كبير وسعادة من هذه الخِبرة المثيرة خصوصاً في فصلِ الربيع. حيثُ تكون الشمس قد أشرقت وملأت المكان بأشعتها الدافئة، ولا تزال آيات القرآن حُلوة ندية ترقرق في مسامعي، فقد اعتاد الإمام الشيخ قراءة سورة الرحمن كاملة في الركعةِ الثانية بصوته العذب، وكان شخصيةً محبوبة من جميع الناس. كنتُ أعود من المسجدِ سعيدًا منشرح الصدر، وقد استقرّ هذا الإنطباع في أعماقِ نفسي واضحًا مشرقاً في وسطِ ضباب كثيف من الخبراتِ الأليمة التي أحاطت بحياتي عبر السنين“.
هذا المُجاهِد المُجتهد -كما سمَّاه المسيري- كانَ حالة نادِرة فِي عالمنا الإسلامي؛ فإنكَ يندُر -وتجنَّبتُ لفظة يستحيل- أن تجِد رئيسًا على هذا المستوى الرفيع مِن الفِكرِ والثقافة. قادَ شعبه الأعزل في أحلك فترات تاريخه ضِد التدخل الصِّربي الغاشِم، وضِد تواطؤ ومؤمرات العالَم الغَرْبي الظالِم.
استحقَ جائزة الملِك فيصل على كِتابه العظيم «الإسلام بينَ الشرقِ والغرب» عام ١٤١٣ھ/١٩٩٣م. قضى رحِمه الله في السجون اليوغسلافية زهرة شَبابه وشطرًا من كهولتِه، والسبب؟ أنه كانَ دائمًا في أقوالهِ وأفعالهِ رافعًا لرايةِ الحَق، لا يَقبل الانحاء إلا لخالِقه.
أفلا تراه يتساءل أحد الأيام قائلاً: ”خلقنا الله نسير منتصبي القامة، بخلاف الحيوانات. بيد أن كثيرًا من الناسِ لا ينتفعون بهذه الهبة؛ فيقضون مُعظم حياتهم منحنين، بل زاحفين. كيف يقدر المرء على ذلك؟ أليسَ من الكُفر أن نُنكر هذهِ النعمة العظيمة من الله؛ نِعمة السير منتصبي القامة؟!“. كتب هذا في السِّجن! نعم؛ في المكان الذي ابتكره الإنسان لسحقِ كرامة أخيه الإنسان.
عندما انتُخِبَ رئيسًا رفضَ أن يغادر منزله المتواضع، وكانَ في شقةٍ صغيرة مع أسرته. فضَّل العيش في سراييفو المُحاصرة، وهي تُقصف بالقذائفِ لمُدة أربعة أعوام! لم يُحب فِكرة العيش في رخاءٍ وأمن بعيدًا عن شعبهِ الذي يعاني، أحب أن يتحمل شظف العيش معهم، ويُحِس بمخاطرهم اليومية.
قال عن الوطن في «هروبي إلى الحرية» صـ١٨٨: ”لِماذا لا يَستطيع المرء أن يَهجر وطنه؟ لا يُمكن لهذا أنْ يَحدث لأننا لا نَستطيع أنْ نأخذ معنا المقابر، فمَقابر آبائنا وأجدادنا هيَ جذورنا، والنَّبات الذي يُجتَثّ مِن جذورِه لا يُمكن أن يَعيش. ولذلك، علينا أنْ نَبقى“. وكتبَ متحدثًا عن الوَطَني الحقيقي في ذات الكتاب صـ١٦٥ : ”ليسَ الوطني الحَقيقي هوَ مَن يرفع وطنه فوقَ الأوطان الأخرى، وإنَّمَا هوَ مَن يعمل حتى يكون وطنه أهلاً لهذا التمجيد، كما أنَّهُ يحرِص على كرامةِ وطنه أكثر مِن حرصه على تَمجيده“.
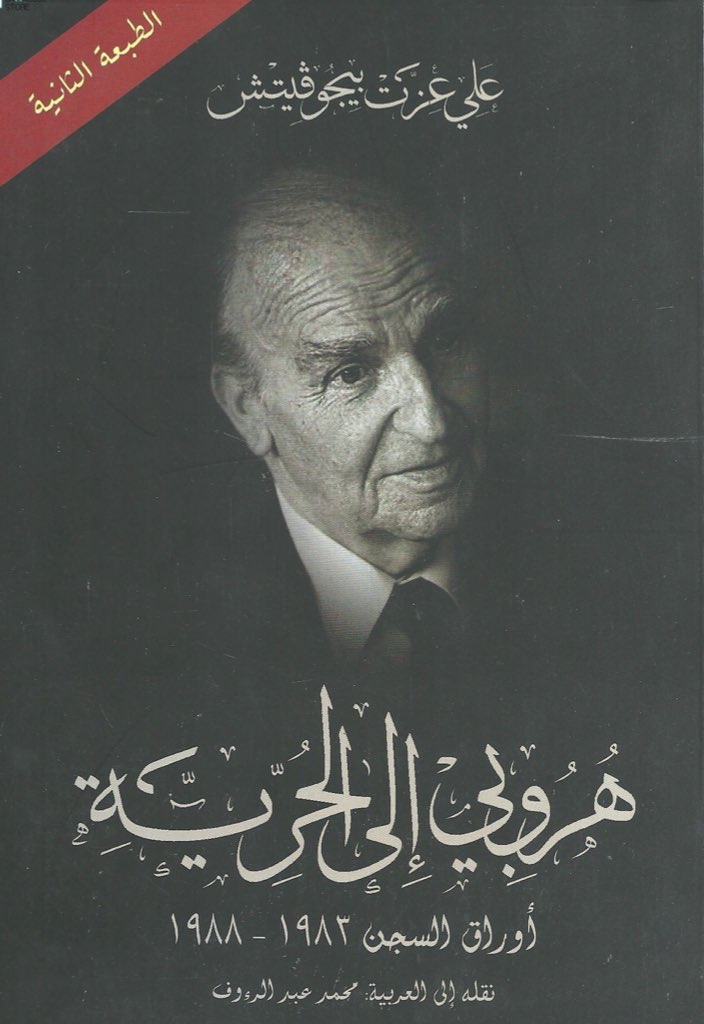
كانَ الجيش الصربي يُردِّد أنشودة شعبية يتوعد فيها علي عزت بالقتل، وهي: ”سَنذبحك يا علي عندما تقوم الحرب كما ذبح ميلوس مراد“. يشيرون إلى السلطان مراد الذي هزم الصرب في كوسوفا، وميلوس الصربي الذي قتله بخنجرٍ مسموم غدرا. بيغوڤيتش لا يزال حيّا وأعداؤه نتنى في مزابل التاريخ.
في سيرته صـ٦٩٠ قالَ عن أولئك عُشّاق الحياد: ”إن هَذا الزمن بالفعل هوَ زمن التناقض، ولَم يَحدث أبدًا أن تَصادم الخير والشر على هذا النحو الواضح، فحتى الشخص الأعمى يُمكنه تمييز ومعرفة ماهية كل منهما (أيهما الخير وأيهما الشر) لكن مع ذلك فهُم حياديون، العار والخِزي لهم“. لذلك كان ثابتاً واضحاً في موقفهِ عندما اعتُقل عام ١٩٨٣م مع ثلاثة عشر من المفكرين والمثقفين الإسلاميين، كانت تهمتهم القيام بثورة مضادة والتآمر ضد السلطة، وانفرد علي عزت من بينهم جميعا -وذلك بسبب كتابه «الإعلان الإسلامي»- بتهمة التمهيد لقلب الحكم، وتأسيس دولة إسلامية في البوسنة!
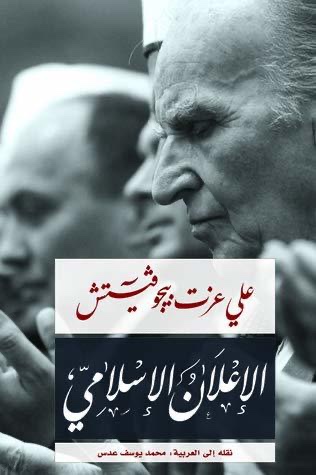
جرَت محاكمة عبثية أشبه ما تكون بمسرحيةٍ هزلية، لم يتضعضع فيها، ولم يلتمس لنفسه العفو، وإنما وقف بشجاعةٍ في محاكمته قائلاً: ”أود أن أِقرِّر هُنا أنني مسلم وسأبقى كذلك تحت كل الظروف، فأنا أعتبر نفسي مناضلاً من أجل الإسلام في هذا العالم، وسأظل ملتزما بموقفي ما دام في صدري نَفَسٌ يتردد“.
خمسة عشر عاما كانت من نصيبه، كان هذا قرار المحكمة العادِلة! خُفِّض الحكم لاحقاً إلى اثنتي عشرة سنة، وهذا بعد التماسات جاءت من بعض المثقفين في بلجراد ومن خارج يوغسلافيا. ولأنه سجين سياسي؛ عانى من التضييق الشديد، ولولا إيمانه العميق سقط ضحية اليأس.
يُحدِّثنا في مذكراته عن حاله في السِّجن قائلاً: ”شعرتُ أنني محكوم عليّ بالسجن إلى الأبد، وأنني لن أرى أحدا ولن يراني أحد بقية حياتي، ومع ذلك لم أستسلم لليأس، وليس في هذا بطولة، ولكن كان الأمر يتعلق في نظري بالثبات والاتساق الجواني مع الإيمان والعقيدة. فالإنسان قد يقول أشياء يؤمن بها فعلاً، ولكن عندما تأتي لحظة الحقيقة إذا بشعورهِ نحوها يختلف، فمثلاً كنتُ أعلم أن من أهم مبادئ الإسلام وتعاليمه؛ الإيمان بالقضاء والقدر وأن على المسلم المؤمن أن يتقبّل كل ما يحدث له باعتباره مشيئة الله وإرادته. والحق أنني لم أفكر في هذه الناحية من قبل بنفسِ الطريقة التي بدأتُ أفكِّر بها بعد تجربة السجن هذه المرة، فعندما واجهت حقيقة احتمال أن أقضي بقية حياتي وأن أموت بين عتاة المجرمين لم يتناقص إيماني، وإنما انبعث في أعماق قلبي بقوة موازية لقسوة الظروف المطبقة في السجن. فشعرتُ بنوعٍ جديد من التناغم بين العقيدة والمحنة مما جعلني في حالةٍ عقلية سوية متوازنة، وساعدني في الحفاظ على صحتي البدنية أيضا، وعلى العموم فقد حمدت الله كثيرًا على نِعمة الإيمان الذي أعانني على التفاعل بإيجابية مع محنة السجن“.
ثم وصفَ -رحمه الله- الزمن عند السجين، فقال: ”الزمن في السِّجن ليس هو الزمن الذي اعتدنا عليه في الحياة العادية، فهو يتثاءب ويتمطى ويمضي بطيئاً ثقيلاً يجثم على القلوب كالكابوس ويكاد يقطع الأنفاس في الصدور، وهو لا يُحسب بالأيام والأسابيع والشهور، وإنما بالساعة والدقيقة والثانية!“. ولقد عاشَ هذا الزمن بنفسهِ، ولعلّك قرأتَ ما ختمَ به كتابه «هروبي إلى الحرية»، عندما ذكر أنه في ٢٥ نوفمبر ١٩٨٨م دخل عليه قائد الحرس كورومان وأخبره بقرار إطلاق سراحه، يكتب: ”كانَ ذلك اليوم هو الخامس والسبعين بعد الألفين منذ اعتقالي“ كان يحسب الأيام!
أحب زوجته «خالِدة» حبّاً عظيما، قال عنها في سيرته: ”في عام ١٩٤٣م عندما كنتُ في الثامنة عشرة قابلت زوجتي خالدة. كنتُ أحب هذهِ الفتاة جدًا، وليسَ من المخجل أن أقول هذا. لقد كانَ حبًا يمكن أن أضحي بنفسي من أجله. لما ذهبتُ إلى السِّجن انتظرتني هذه الفتاة لمدة ٣ سنوات قضيتها في السجن!“.
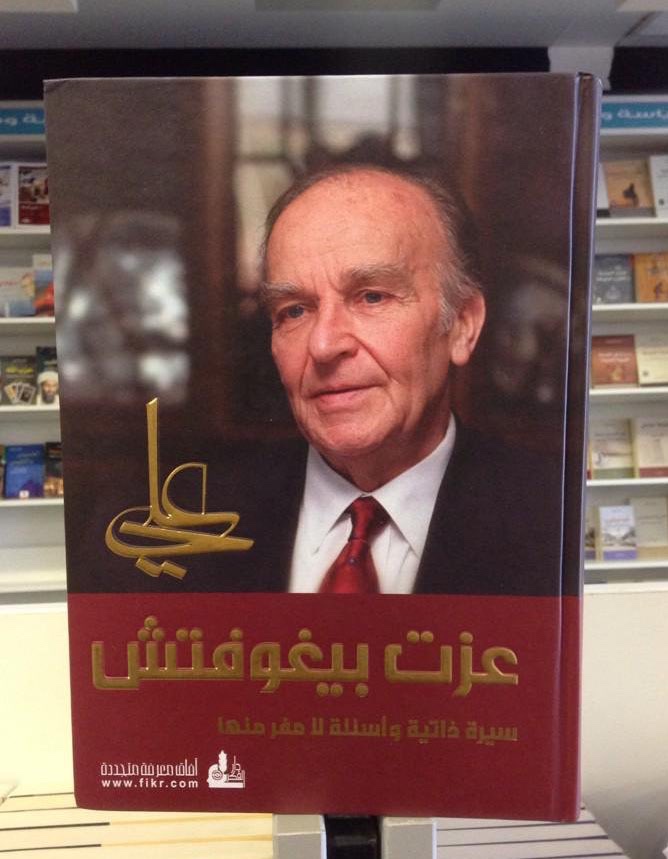
كانَ مُعجبًا بمحمد علي ويحلم بلقائه، وهذا ما تم عندما كان في أمريكا. يقول بيغوڤيتش: لما أخبرته بأن اسمي علي، رد بأنه يعرف ذلك. ثم قال: ”شعرتُ بقُرب أخوي من هذا الرجل“. قال لاحقا: ”عندما عدتُ إلى البوسنة الذين سألوني عن لقائي بمحمد علي أكثر من الذين سألوني عن مواجهتي لكلينتون!“.

في الخامسِ من نوفمبر عام ١٩٩٤م أجرت مجلة «شتيرن» الألمانية لقاء صحفياً معه، فسأله مندوبها سؤالاً مستفزّاً أجابَ عليه بيجوڤيتش إجابة عبقرية أحببتُ أن أضيفها هنا للإثراء والفائدة.
سألهُ المندوب: السيد الرئيس، أنتَ معروف كمُسلم حريص على التقاليد الأوروبية والتسامح الأوروبي، وأنكَ منفتح على العالمِ بأسره، ولكن هناك تقارير صحفية تزعم أن هناك أسْلمةٌ جارية في البوسنة والهرسك، فهل هذه مجرد شائعات؟
(وأنا أريد منكم أن تتأملوا وتقرؤوا جيّدًا إجابة هذا الرجل العظيم، الذي يفهم العقلية الأوروبية، ويعرِف كيف يخاطبها بمنطق المواجهة الحَكيمة، ولا يَلجأ إلى لغةِ الاعتذار المهين والتبرير المُذل).
أجاب بيجوڤيتش:
سوف أكون شديد الصراحة وأقول لك: لا ليست هذهِ شائعات بل حقيقة، وتفسيرها أن العودة إلى الدِّين أصبحت ظاهرة عالمية في كلِّ مكانٍ قَمَع فيه الشيوعيون الدِّين على مدى خمسين إلى سبعين سنة. نعم هُناك أسْلَمة في البوسنة -على حدِّ وصفك- وهي صحوة إسلامية، بقدر ما فيها صحوة أرثوذكسية وكاثوليكية، ولكن الفرق هو أن عودة المسيحيين إلى دينهم لم تلفت انتباه أوروبا المسيحية، وهو أمر أفهمه ولا ألومها عليه، أما عودة المسلمين إلى دينهم فقد اعتبرَته أمرا مفزعا !
وأود فقط أن أُصحِّحَ لك نقطة واحدة، وهي أن تسامحي ليس مردُّه إلى أنني أوروبي، وإنما مصدره الأصلي هو الإسلام. فإذا كنتُ متسامحًا حقّاً فذلك لأنني أولاً وقبل كل شيء مُسلم ثم بعد ذلك لأنني أوروبي.
لقد لاحظتُ خلال حرب البوسنة أن أوروبا تسيطر عليها ضلالات وأوهام لا تستطيع التحرُّر منها رغم الحقائق الدامغة. فقد دُمِّرت في هذهِ الحرب مئات المساجد والكنائس، كلها -بلا استثناء- دمّرها مسيحيون، ولا توجد حالة واحدة لكنيسة دمّرها البشناق (المسلمون). أسوق إليك حقيقة تاريخية أخرى: فقد حكم الأتراك العثمانيون البلقان ٥٠٠ سنة، فلم يهدموا كنيسة ولم يبيدوا شعباً، بل حافظوا على الأديرة الشهيرة في جبال فروشكا جورا (قريباً من بلجراد) لأن إسلامهم يأمرهم بهذا. ولكن هذه الآثار الدينية التاريخية لم تصمد ثلاثة أعوام فقط تحت الحكم الأوروبي.
دمّرها الشيوعيون والفاشيون خلال الحرب العالمية الثانية، وهؤلاء لم يكونوا نتاجًا آسيويا بل صناعة أوروبية، وحتى هذه اللحظة لم تُظهر أوروبا حساسية ضد الفاشية المتصاعدة في البلقان، ووقفت تتفرج على الخراب الذي أحدثه الصرب في البوسنة.
في كتابهِ «الإسلام بين الشرق والغرب» صـ٦١ يقول: ”الإسلام ليسَ مُجرد دين أوْ طريقة حيَاة فقط، وإنمَا هوَ بصفةٍ أساسية مَبدأ تَنظيم الكون“. ويعجبني قوله في ذات الكِتاب صـ١٧٩: ”ليست الإنسانيّة في الكمال أو العِصمة مِن الخطأ. فأنْ تُخطئ وتندم هوَ أن تكون إنسانًا“.

عندما نتحدث عن هذا الرجل العظيم، يجب علينا أن نستحضر اسم غريب وهو «حسن بيبر». هذا الرجل كان صديقًا مقرّباً من علي عزت. بعد خروج بيجوڤيتش من سجنه الأول (١٩٤٦-١٩٤٩م) بأربعين يوماً أُلقي القبض على صديقه، وتعرّض لأشد العذاب حتى يعترف بأنَّ علي عزت عاد إلى ممارسة نشاطه، رفض بيبر وصبر، ثم أُعدم رمياً بالرصاص. إن بيجوڤيتش مدين بحياته -بعد الله- إلى هذا الحر الشريف.
كتبَ مرّة: ”قلّة قليلة من الناس هي التي تعمل وفقا لقانون الفضيلة، ولكن هذه القلة هي فخر الجنس البشري وفخر كل إنسان. وقليلة هي تلك اللحظات التي نرتفع فيها فوق أنفسنا فلا نعبأ بالمصالح والمنافع العاجلة، هذه اللحظات هي الآثار الباقية التي لا تبلى في حياتنا“.
روى لنا الشاعر البوسني عبدالله سيدران -وكان صديقاً قريباً من بيجوڤيتش- أنه عندما زاره في آخر حياته، قال له جملة مهمة لَمْ يكتبها في أيٍّ من كتبه، وهي: ”إن الأشياء التي لها قيمة في حياةِ الإنسان، هي فقط الأشياء التي تعطيه القدرة على الاحتفاظ بالكرامةِ الإنسانية“.
أختم الكلام عنه بتساؤلٍ له في «هروبي إلى الحرية» صـ١٣٢ قال: ”هل صحيح أن الأمعاء الخاوية هي وحدها ما يُحرِّك التاريخ؟“. ماتَ رحمه الله وفي نفسه الكثير لهذهِ الأمة. للأسف لَمْ يجد حوله من يُسانده في طريقه، حاله كما قالَ هو ذات يوم: ”كنتُ على حقّ في الزمنِ الخطأ“.
والسلام.

رحمه الله رحمةً واسعة..
جزاكم الله خيراً على هذه المقالة..
إعجابإعجاب
رحمه الله … نسأل الله أن يسخر للأمة الإسلامية حكام مثل علي عزت بيجوفتش
إعجابإعجاب
رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
إعجابإعجاب
لاعز لنا الابالاسلام..رحمه الله وغفر له
إعجابإعجاب
رحمه الله تعالى ، أسأل الله أن يجزيه خيرا على ما قدّمه في خدمة الإسلام وأهله.
إعجابإعجاب